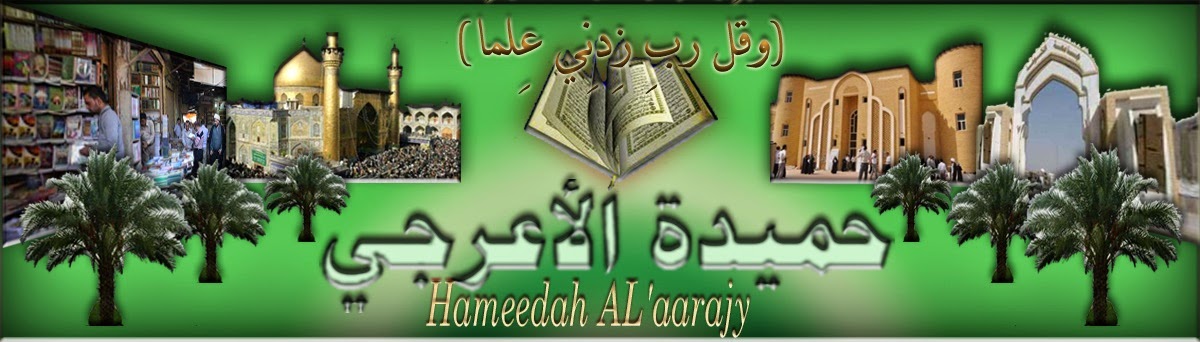وُجِد الإنسان الأول وهو محمّل بعقل كامل قادر على التمييز بين الحَسَن والقبيح من الأشياء؛ لِما أودعه الله - سبحانه - فيه من علم. يؤيد هذا، شعور آدم وحواء (عليهما السلام) بالحياء لما بدت لهما سوءاتهما بعد خطيئتيهما - حسب الرواية القرآنية - ]...فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ...[([1])؛ فبادرا إلى سترهما على الرغم من أنهما كانا من المحارم ولم يكن هناك من أحد معهما، ولم يزودا بعد بشريعة السماء، إلّا أنَّ العقل هو الذي بيّن لهما أنَّ انكشاف السوءة قبيح ولابد من ستره.
ولما هبطا على الأرض زودهما الله
تعالى بتعاليم السماء وشرع لهما ولذريتهما الشريعة التي تتواءم والفطرة الإنسانية
السليمة، بدليل الحوار الذي دار بين الأخوين هابيل وقابيل بعد أنْ أراد الثاني التعدي
على الأول بقتله، فكلاهما كانا يعلمان أنَّ القتل فيه تعدٍ، وفيه إثم يتّبِعه غضب
وعقاب من الله U، كما في قوله تعالى على لسان هابيل ع : ]لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ
يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ[ ([2])
إذن فتعاليم السماء أكّدت - بالإضافة إلى ما عَلِمه العقل مسبقاً - بأن القتل من القبائح، بيد أنها أضافت إليه استتباعه لمبدأي الثواب والعقاب المبتنيان على اختيار الإنسان، فاختار هابيل رضا الله U وثوابه، واختار قابيل غضب الله تعالى وعقابه.
ومن المعروف أنَّ الإنسان يولد وهو
متصف بأخلاقٍ ما بالقوة، وقد تكون هذه الأخلاق أو الصفات متوارثة عن آبائه، أو مما
أودعها الله - سبحانه - فيه تلطّفاً به، بعد أنْ علم منه الخير في الأزل. وما أنْ
يكبر وتظهر عليه معالم الإنسانية حتى تصدر عنه صفات هذه الأخلاق إلى الفعل - سواء
على المستوى الإيجابي أو على المستوى السلبي - ولكن من فضل الله تعالى على عباده، لم يجعلهم أُسارى لهذه الصفات، وإنما زوّدهم بالقدرة على الاختيار،
وقوة الإرادة التي تمكّنهم من تغيير صفاتهم من قبائح الأخلاق إلى فضائلها.
ولم يتوقف عطاء الله تعالى عند هذا الحد وحسب، وإنما تواصل لطفه - سبحانه - على عباده، بأنْ
أرسل إليهم من أنفسهم رسلاً هادين مهديين، وأوكل إليهم وظيفة هدي العباد إليه عز
وجل، بإراءتهم الصراط المستقيم الموصل إلى رضا الله تعالى، والفوز بعطائه الأبدي
في الدار الآخرة ]...خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ
مِنَ اللَّهِ قِيلًا[([3]).
ومن خلال مسيرة البحث السابقة، تمكن من الخروج بالنتائج الآتية:
أولاً: صفات الأفعال الأخلاقية ثابتة في عالم الوجود، سواء وُجِد الإنسان أم لم يوجد على هذه الأرض، ولكنها لم تُدرس كعلم يُعلّم ويُتعلّم إلّا على يد فلاسفة اليونان، الذين نظّروا لها من أجل سعادة الإنسان والرقي به إلى العيش في مجتمع منظم وسعيد، واستفاد فلاسفة الإسلام ومتكلموه من هذا العلم بعد عصر الترجمة، واستطاعوا أنْ ينهضوا به بعد أنْ أضافوا إليه تعاليم السماء، على الرغم من أنَّ بعضهم نقل هذا العلم نقلاً حرفياً وآمن بهذا النقل، الذي يوحي إلى الجبر في أفعال الإنسان، إذ بدا ذلك واضحاً من خلال تعريفاتهم للأخلاق.
ثانياً: تباينت الآراء بين أعلام الفلاسفة والمتكلمين في ماهيَّة الحسن والقبح العقليين لأن بعضهم نظر إلى صفات الأفعال بما يعرضها من الأعراض - من حيث اللّذة والألم والملائمة والمنافرة والأمر والنهي... إلخ- ولم ينظروا إلى الأفعال بما هي هي مجردة عن كل عَرَض أو غَرَض.. ومن هنا كان الخلط بين الثابت والمتغير؛ لأنَّ الذي يتغير وتتغير بتبعه العادات والتقاليد لا صلة له بالأخلاق وثباتها.
ثالثًا: الأخلاق النفسانية ليست طباعاً ذاتية في الإنسان، وهي قابلة
للتغيير عن طريق التهذيب بالدربة والمران، بدليل قبول الطفل للتربية والسياسة،
وقبول الكبير لتهذيب النفس متى ما عزم على ذلك، وهذا من فضل الله على عباده أن جعل
أنفسهم مستعدة لقبول كافة الصور على تمامها، فكلما ارتاض الإنسان ازداد فهماً
وتعلماً، وبإمكانه إخضاع قواه الغضبية والشهوية لقوة العقل بالرياضة والمجاهدة. ومن هنا جاء
تأكيد الشرائع السماوية على تهذيب النفس وتزكيتها بالعبادة والتخلّق بالأخلاق الحسنة.
رابعًا: تميَّز التقنين السماوي للأخلاق عن التنظير اليوناني، بأنه استمد
أحكامه من جهة حكيمة محيطة عالمة بحوائج الإنسان وبما يُصلحه، وهذه الجهة ألزَمت
المكلّف بمبدأي الثواب والعقاب واشترطت نية القربة إلى الله تعالى في العمل؛ لكي يكون له دافعاً في الانبعاث أو الانزجار، على عكس
التنظير الثاني الذي استند إلى القوانين العقلية المجردة التي لا تلزم الإنسان
بشيء سوى وعده بالحصول على السعادة واللّذة في عالم الدنيا إذا ما استقام في
أفعاله.
خامسًا: إنَّ العقل المجرد قادر على إدراك بعض من أنواع العبادات قبل ورود
الشَّرع على الجملة. وأنَّ جميع العبادات أفعال أخلاقية عقلية قبل أن تكون أوامر
وإلزامات شرعية، لأنها لا تخلو من أنْ يكون فيها شكر للمنعم، وطاعة للمولى، وطلب
منه، وهذه الأفعال يستقل العقل بوجوبها على نحو الموجبة الجزئية. أما تفاصيل هذه
العبادات فلا يمكن للعقل إدراكها؛ لقصوره ولعدم إحاطته بملاكات الأحكام.
سادساً: هناك تشابه إلى حدٍ كبير قد يصل إلى المطابقة - أحياناً - بين
أحكام الفقه في الشرائع السماوية، فما هو حسن أمرت به، وما هو قبيح نهت عنه، على
الرغم من التحريف الذي طال كتابي التوراة والإنجيل، إلّا أنَّ هناك من تفاصيل
الأحكام ما ميَّز هذه الشرائع بعضها عن بعض. فقد امتازت أحكام الشريعة اليهودية
بالشدة والحزم والاستيفاء الكامل، سواء في فقه الفضائل أو في فقه الرذائل، إذ
اهتمت بظاهر هذه الأحكام أكثر من اهتمامها بالجانب الروحي لها. وهذا على عكس ما
ميَّز الشريعة النصرانية، التي غلّبت الجانب الروحي الباطني العرفاني على الجانب
الظاهري في فقه الفضائل، وغلّبت العفو والمسامحة المفرطة في فقه الرذائل، وضيعت
بذلك أحكام الله U وحدوده. في حين تميَّزت الشريعة الإسلامية عن سابقتيها، بأنها
كانت وسطاً بين الشريعتين في أحكامها، سواء على مستوى فقه الفضائل أو على مستوى
فقه الرذائل، الأمر الذي راعت معه مصلحة الإنسان بكلا جانبيه الروحي والبدني.
لقراءة الكتاب كاملًا .. اضغط هنـــــــــــا